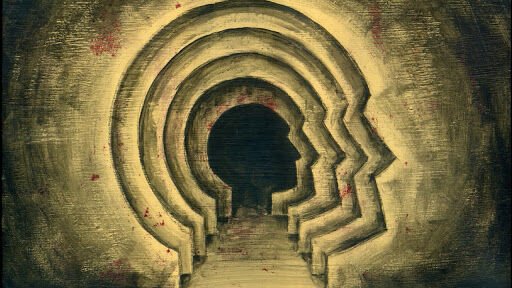مدركية
العقل وكاشفيته(3)
التفريق بين حكم العقل والرغبات الخاصة:
قد عرفت أن بناء علماء الطائفة على حجية العقل في الأمور التي يستقل بإدراكها كاستحالة اجتماع النقيضين، وحسن العدل، وقبح الظلم، إلا أن ذلك لا يعني فسح المجال للرغبات الخاصة، والأمزجة في إعمال العقل، لأن البعض قد يخلط بين الأحكام التي يدركها العقل الفطري، وبين الأحكام التي تستند إلى الأهواء والميول والرغبات، ولذا يعمد إلى محاسبة الفقهاء على بعض الأحكام التي لا تنسجم وهواه ورغباته، ومن ذلك مثلاً الاعتراض على الفقهاء بأنهم قد ذكروا أنه لو كان عندك ماء كر، وبال فيه كلب، ولم تتغير أوصافه الثلاثة، فإنه لا يحكم بنجاسته، أما إذا شرب الكلب من ماء كر بحيث نقص الماء عن كونه كراً، ولو بمقدار كأس، حكم عليه بالنجاسة، وهذا خلاف حكم العقل، إذ كيف لا ينجس الماء ببول الكلب فيه، وينجس بملامسة فمه، أي عقل هذا الذي يقبل بالتفريق بين الموردين، ليحكم في أحدهما بالنجاسة، وفي الآخر بعدمها.
ولا يخفى ما في هكذا أمر وغيره من الخلط عند هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الإشكالات والتساؤلات ويسددون سهامهم تجاه الفقهاء، فقد خلط بين ما يدركه العقل الفطري، وبين ما يتوافق ويتناسب مع مزاجه، فإن العقل يقرر بأن من المحتمل أن تكون هناك مصلحة في عدم تنجس الماء حال كونه كراً بأي شيء من النجاسات، بينما يتنجس بملاقاة أي شيء منها إذا كان أقل من الكر، وذلك لأن هذا من الأمور التعبدية التابعة لملاك المصلحة والمفسدة، والتي لا يمكن للعقل أن يدركها كما عرفت.
وللأسف أن مثل هذه الأمور من اتباع الأمزجة والأهواء يكثر عرضها ويسعى من خلالها إلى انتقاص الفقهاء والحط من قدرهم، كمسألة ثبوت الهلال بقول الفلكي، وأمثال ذلك كثير.
المنهج وموارد تطبيقه:
بقي أن نشير لأمر مهم، يحسن الالتفات إليه، وهو التفريق بين المنهج وموارد تطبيقه، توضيح ذلك:
من الدعاوى المثارة بين فينة وأخرى حيال فقهاء الطائفة المحقة، اتباعهم للمنهج الأشعري، وإقصائهم العقل، وقد عرفت مما تقدم، عدم تمامية ذلك، لبناء الأعلام وتعويلهم على العقل في موارد كما سمعت. نعم يحصل الاختلاف بينهم في مورد التطبيق، وأن هذا المورد من صغريات إدراك العقل الفطري، فيحكم مثلاً بحسن هذا الأمر، أو يحكم مثلاً بقبح هذا الأمر؟
ومن الواضح أن الخلاف الحاصل خلاف صغروي، وليس كبروياً، ولا يدل على رفض حكم العقل، أو عدم التعويل عليه.
دور العقل في التطبيق:
وكما أن للعقل دوراً في الحاكمية والإدراك حال القبول بذلك، فإن له دوراً أيضاً في عملية تطبيق الأحكام، فهو الذي يتصدى لتحديد صغرى الحكم، ففي قوله تعالى:- (فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)، فإن العقل هو الذي يتصدى لتحديد كيفية الاصلاح، سواء كان إصلاحاً للنفس، أم كان إصلاحاً للأسرة، أم كان إصلاحاً للمجتمع، أم غير ذلك.
ويتدخل أيضاً حال حصول التزاحم بين حكمين شرعيـين، ليقدم الأهم منهما على المهم، كما أنه المرجع عند الشك في تحقق امتثال التكاليف من عدمه.
وصول العقل إلى الحكم الشرعي:
قد عرفت في القول الأول، أن العقل مجرد مدرك لحسن الأشياء وقبحها، وأنه لا يأمر العبد ولا ينهاه، وأن دوره لا يتعدى دور المرآة التي تعكس حقائق الأشياء في الأذهان.
وقد عرفت في ما تقدم أن حجية العقل عند أصحاب هذا القول محمولة على أحد معنيـين تقدمت الإشارة إليهما.
1-الالتـزام بالملازمة بين إدراك العقل للحسن والقبح، وبين حكم الشرع، فكلما أدرك العقل فإن الشرع يحكم عندها. وعلى هذا ينحصر طريق وصول العقل إلى الحكم الشرعي إذا توصل إلى وجود ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ولا يمكن الوصول إليه من دونها.
وعندها يأتي السؤال: كيف يحكم العقل بالملازمة بين ما يحكم به، وبين ما يحكم به الشرع؟
ويجاب، بأن هناك طريقين يصل العقل من خلالهما إلى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهما:
الطريق الأول: العقل النظري، وقد سبق تعريفه، بأنه ما ينبغي أن يعلم، ويقصد منه الأمور التي لها حقيقة وواقعية ويدركها العقل.
وهنا يصل للملازمة في الأمور التي يدركها العقل بالبداهة والوجدان، أو تنتهي إليهما، ويمكن ذكر أمثلة لذلك:
منها: حكمه بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فالصلاة واجبة فيحكم العقل بوجوب جميع المقدمات التي يتوقف وجودها عليها كالطهارة، فلو لم يدل دليل على وجوب الوضوء مثلاً كان مقتضى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هو البناء على وجوبه ما دام قد دل الدليل على وجوب الصلاة.
ومنها: حكمه بقبح العقاب بلا بيان، فيستفاد حكماً شرعياً بجواز العمل في كل شيء مشكوك، فلو شككنا في حرمة التدخين مثلاً، كان مقتضى القاعدة المذكورة الحكم بحليته وعدم حرمته، نعم هذا بمقتضى الحكم الأولي، ويمكن أن يحرم بمقتضى الحكم الثانوي.
ومنها: حكمه بوجوب تقديم الحكم الأهم على الحكم المهم حال وقوع التـزاحم بينهما، وعدم قدرة العبد على الجمع بينهما، كما لو دار أمر المرأة الحامل بين خطرين: حياتها، أو حياة الجنين الذي في بطنها، فهنا أمران:
1-الاجهاض، وقتل الجنين حفاظاً على حياتها.
2-عدم الاجهاض، وتعريض حياة الأم للخطر.
والمفروض أن الطبيب عاجز عن الحفاظ عليهما معاً، فهنا يحكم العقل بلزوم تقديم الأهم والتضحية بالمهم، والأهم هنا هي حياة الأم لأنها حياة كاملة متيقنة، ويجب عليها أن تدفع عن نفسها ما يضرّ بها، فيستفاد من حكم العقل بلزوم تقديم الأهم حكم الشرع بذلك، لأن الشرع لن يختار غير الأهم.
الطريق الثاني: العقل العملي، وقد عرفت حقيقته في ما تقدم، وأنه ما ينبغي أن يعمل، ويقصد منه الأمور التي يقضي العقل بلزوم فعلها، وعدم جواز تركها، فإذا أردك العقل حسن شيء أو أدرك قبحه، أو أدرك مصلحة فيه، أو مفسدة، فإنه يستقل بالحكم بلزوم فعل الحسن وتحصيل مصلحته، ولزوم اجتناب القبيح ودفع مفسدته.
ومن هنا نجد أن العقلاء يندفعون لتسيـير أمورهم وتدبير معاشهم واتخاذ مواقفهم.
ولا يخفى أن هذا الإدراك العقلي مجرداً لا يكفي للوصول إلى الحكم الشرعي، بل لابد من وجود الملازمة بين ما يحكم به العقل، وما يحكم به الشرع، ليقال عندها:
إن ما استحسنه العقل فإن الشرع يحكم بوجوبه، وما استقبحه العقل، فإنه الشرع يحكم بحرمته، فالعدل لما كان العقل يستحسنه، فإن الشرع يحكم بوجوبه، ولما كان الظلم مستقبحاً عند العقل، فإن الشارع يحكم بحرمته.
والحاصل، إن طريق وصول العقل للحكم الشرعي مبني على وجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ولولاها لا يمكن أن يتوصل من الحكم العقلي إلى حكم الشرع ابداً، لأن الشرع أوسع من العقل، فيتعذر على العقل أن يتوصل إلى معايـير الشرع دائماً.
ويترتب على ذلك نتيجة مهمة، أنه لا يلزم أن يكون كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع، وإنما يختص ذلك في حالة كانت هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فإن الشرع يحكم تبعاً لذلك، فيكون حكم العقل علة لحكم الشرع.
ومن المعلوم أن الملازمة المذكورة ليست موجودة دائماً وإنما في صورة وجود الحسن والقبح العقليـين، لأنه يتفق الحكم الشرعي والعقلي بنحو التطابق فيهما فقط، ولهذا اتفق العقل والشرع على وجوب الصدق، ورد الأمانة إلى أهلها، وشكر المنعم، وحفظ النظام، مما يستقل العقل بحسنه، كما أنه يستقل بقبح الكذب، والخيانة، والفوضى، والعدوان، وغير ذلك.
نعم هناك موارد مع حكم العقل فيها بشيء من المصالح والمفاسد، إلا أن الشرع يخالفه، لوجود أمور لا يدركها العقل، بل تخفى عليه، كما في الربا، فإن العقل يحكم بحسنه، بل ربما عدّه منفعة لآخذه، وأنه نحو من أنحاء التجارة، إلا أن الشرع يحرمه لوجود مفاسد كبيرة فيه لا يدركها العقل.
وكذا تحريم بعض محرمات الإحرام مثل شمّ الطيب، ولبس المخيط، فإن تحريمها لا ربط للعقل بها من قري أو بعيد، بل قد يكون العقل مدركاً لحسن الاتيان بها، ومع ذلك نجد الشارع قد حرّمها.
النصوص المانعة من حكم العقل:
قد عرفت أن دليلية العقل تتوقف على ثبوت الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع، وأن ذلك ينحصر في الحسن والقبح العقليـين، إلا أنه قد يشكل على ما ذكر بالنصوص التي تضمنت النهي عن الاستناد إلى العقل في الأحكام، وأنه لو استند إليه لزم محو الدين، وإبطاله:
منها: إن دين الله لا يصاب بالعقول.
ومنها: إن السنة إذا قيست محق الدين.
ومنها: إنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس.
ومن ذلك أيضاً ما ورد في حديث الإمام أبي عبد الله الصادق(ع) مع أبي حنيفة-في حديث- يا نعمان، حدثني أبي عن جدي: أن رسول الله(ص) قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس. قال الله تعالى له: اسجد لآدم، فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه أتبعه بالقياس[1].
ويمكن الجواب عنها:
أولاً: بأنها معارضة بنصوص أيضاً تضمنت إثبات حجية العقل، ولزوم الرجوع إليه ولو في بعض الموارد:
منها: ما جاء عن النبي الأكرم محمد(ص) أنه قال: استرشدوا العقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا.
ومنها: ما جاء عن الإمام الكاظم(ع) أنه قال: إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فإرسال الرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول.
ومنها: ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) أنه قال: وما من شيء عبد الله به أفضل من العقل.
ومع حصول المعارضة، يعمد إلى التوفيق بينهما من خلال الجمع العرفي، فيقال: تحمل النصوص الناهية عن الاعتماد عليه والركون إلى أحكامه على صورة الاستقلال بالوصول إلى الحكم الشرعي، وقد عرفت في ما تقدم عجز العقل عن الوصول إلى الحكم الشرعي دون مساعدة الشرع، لكونه يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها بعضها، كما يدرك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وأما النصوص التي تضمنت إثبات الحجية إليه فإنها قد أرادت من العقل الوارد فيها هو الذي يستقل بالحسن والقبح والملازمة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
ثانياً: إن المعارضة المدعاة بين النصوص المذكورة غير حاصلة أساساً، لأن موضوع كل واحدة منهما مختلف عن الثانية، ذلك أن موضوع الطائفة المانعة من حجية العقل والعمل وفق أحكامه هو القياس والاستحسان، وما شابه ذلك والتي لا يكون منشأها حكم العقل بحسن شيء أو قبحه، وإنما يكون ذلك ناجماً من اجتهادات شخصية وتحكيم للرأي الشخصي في الدين. ويساعد على ذلك ما ذكره الإمام(ع) في حديثه مع أبي حنيفة، وهذا بخلاف النصوص الدالة على الحجية، فإن موضوعها الموارد التي يكون قول العقل فيها حجة كما عرفت ذلك في ما تقدم[2].
[1] وسائل الشيعة ج 27 ب 6 من أبواب صفات القاضي ح 23 ص 46.
[2] أصول الفقه وقواعد الاستنباط ج 1 ص 265-307(بتصرف).