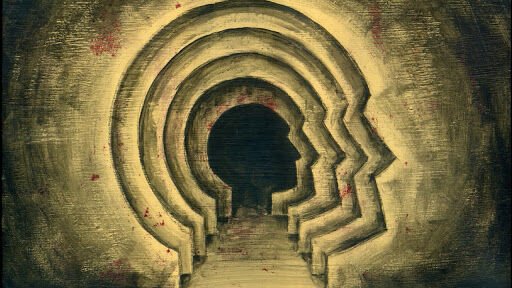مدركية
العقل وكاشفيته(1)
من النقاط التي ذكرت للفرق بين المدرستين الأصولية والإخبارية مرجعية العقل، فقد اعتبره مشهور الأصوليـين أحد مصادر الاستنباط للأحكام الشرعية، ومنع الأخباريون من ذلك.
وينجم عن الاختلاف المذكور حصول السؤال التالي: هل للعقل قدرة على الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا؟
حقيقة العقل:
العقل لغة بمعنى الحبس والمنع، لأنه يحبس صاحبه عن ذميم القول والفعل، والعاقل هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها.
والمستفاد من النصوص أنه نور روحاني تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية. وقد أوجب هذا تقسيمه إلى قسمين: نظري وعملي.
العقل نظري وعملي:
وليس المقصود من القسمين انقسام العقل نفسه إلى ذلك، بل المقصود هو ما يدركه العقل فإنه ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما ينبغي أن يعلم ويقصد منه الأمور التي لها حقيقة واقعية يدركها العقل ويتوصل إليها، وبهذا الاعتبار سمي العقل الذي هو آلة الإدراك بالعقل النظري لأن العاقل يعمل نظره ويتأمل في الوصول إلى النتيجة، ومثاله:
1-إدراك العقل لوجود الخالق سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله.
2-عصمة الأنبياء(ع).
3-حقائق الأحكام الشرعية وغير ذلك.
الثاني: ما ينبغي أن يعمل، ويقصد به الأمور التي يقضي العقل بلزوم فعلها، وعدم جواز تركها، كالعدل، أو لزوم تركها وعدم جواز فعلها، كالظلم، بسبب إدراكه حسن الأول، وقبح الثاني، وهذا هو المسمى بالعقل العملي لأن المدرك يتعلق بالعمل.
ويلاحظ من خلال التقسيم المذكور أن الذي تدور عليه الأحكام العقلية هو الحسن والقبح، فما أدرك العقل حسنه يحكم بوجوب فعله، وما أدرك قبحه يحكم بوجوب تركه.
وهذا يجر إلى الحاجة لمعرفة الحسن والقبح وتحديد المقصود منهما، عندما يقال: هذا حسن، وهذا قبيح.
الحسن والقبح:
عند العودة للمصادر المتخصصة بالبحث عن الحسن والقبح نجدها تذكر لهما معاني متعددة، أهمها أربعة: الكلامي، والأخلاقي، والطبيعي، والعقلي.
1-الحسن والقبح الكلامي:
فالحسن في علم الكلام يطلق على ما يوافق الغرض والحكمة، والقبيح يطلق على ما يخالف الغرض والحكمة، فالوجود حسن لأنه يوافق غرض الخالق، ويدل على كمال صفاته في الخلق والإيجاد.
2-الحسن والقبح الأخلاقي:
ويطلق الحسن في علم الأخلاق على كل كمال أخلاقي، ويطلق القبيح على كل نقص أخلاقي، فالفضائل محاسن لأنها كمالات والرذائل قبائح لأنها نواقص، ولذا يقال العلم حسن، لأنه كمال للنفس والجهل قبيح لأنه نقص لها.
3-الحسن والقبح الطبعي:
ويطلق الحسن في الطبيعة البشرية على كل ما يتلاءم مع الطبع، وأما القبيح فإنه يطلق على ما يتنافر معه.
وقد يعمم ليشمل اللذة والألم، فما يكون فيه لذة يكون حسناً، وما يكون فيه ألم يكون قبيحاً. وتنقسم اللذة إلى أقسام، فإنها قد تكون لذة حسية وذلك كالطعام، وقد تكون لذة نفسية مثل المنظر، وقد تكون لذة عقلية كالفكرة، أو الألم.
ويختلف هذا المعنى عن سابقيه في كونه نسبياً غير ثابت يلائم الطبع وينافره.
4-الحسن والقبح العقلي:
يطلق الحسن عقلاً على كل فعل يستحق صاحبه المدح، وعكسه القبيح، ويعتبر هذا القسم من أهم المحاور التي تدور عليها حياة البشر، فإن العقلاء إذا رأوا فعلاً حسناً مدحوا صاحبه، وحكموا باستحقاقه المثوبة عليه، وإذا رأوا فعلاً قبيحاً ذموا صاحبه وقالوا باستحقاقه العقوبة عليه.
فنظام الثواب والعقاب عند العقلاء قائم على هذا الأساس، ولهذا المعنى من الحسن والقبح خصوصيتان:
الأولى: أنه موضع اتفاق العقلاء، فإنهم متفقون على أن الحسن ما استحق فاعله المدح والثواب عندهم جميعاً، والقبيح كذلك. وهذا يعني ثبوت الحكم وعدم تغيره حسب الاعتبارات والأراء والمصالح، كما لا يتغير بالأماكن والأزمنة.
الثانية: أنه من أوصاف الأفعال الاختيارية للبشر، لأنها هي التي تمدح وتذم، أما الأفعال غير الاختيارية فلا تكون مورداً لمدح ولا ذم، فلا يمدح الشخص لكونه طويلاً أو قصيراً، كما لا يذم لذلك، ولا يمدح شخص لحسن وجهه وطلاقة لسانه، ولا يذم آخر لكونه ذميماً أو غير طلق اللسان.
وعلى أي حال، فقد اتفق العلماء قاطبة على أن الأقسام الثلاثة من معاني الحسن والقبح: الكلامي، والأخلاقي، والطبعي، خارجة عن حريم البحث، وأنها لا ربط لها بالبحث الأصولي، لأنها من شؤون عالم الخلق والتكوين، وما يدخل في البحث الأصولي هو ما يرتبط بعالم التقنين والتشريع، وقد اختلفوا في ذلك فقالت الأشاعرة بعدم قدرة العقل على الإدراك لحسن الأفعال وقبحها، بل يحتاج إلى حكم الشرع، فكل ما حسنه الشرع ومدح فاعله، يكون حسناً، وكل ما قبحه الشارع وذم فاعله يكون قبيحاً، ولا دخل للعقل.
وقالت المعتزلة والإمامية بأن الحسن والقبح عقليان وليسا شرعيـين، فالعقل يمكنه أن يحكم بحسن بعض الأشياء بغض النظر عن حكم الشرع، كما يمكنه أن يحكم بقبح بعض الأشياء. ومن هنا قال بعضهم بأنه لا يمكن للمشرع مخالفته في ذلك حذراً من لزوم التناقض ومنافاة الحكمة لتطابق العقلاء على ذلك، ومن المعلوم أن الشارع من العقلاء، بل هو رئيسهم، وسيدهم.
العقل مدرك وليس حاكماً:
ووفقاً لما تقدم، يأتي السؤال التالي: هل أن العقل مجرد آلة يتم بواسطتها الإدراك والتصور، أم أن العقل حاكم يتصدى للبت والقضاء في الأمور؟
وتظهر ثمرة ذلك في الأحكام، فإنه إذا بني على الأول، وهو كونه مدركاً، فإنه يلزم من ذلك البناء على الوجوب الشرعي لكل ما حكم العقل بكونه حسناً، وعندها تجري القاعدة المذكورة كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع.
أما لو بني على الثاني، وهو كون العقل حاكماً، فسوف يكون الوجوب عقلياً، وليس شرعياً، فإذا جاء دليل شرعي بذلك كان إرشاداً إلى المصلحة، وليس دالاً على الوجوب.
وقد وقع الخلاف بين الأعلام على أقوال:
الأول: أن العقل مجرد مدرك وليست له القابلية على أمر العبد ولا على نهيه، بل هو مجرد آلة تعكس حقائق الأشياء في الأذهان، مثل المجهر، فهو مجرد كاشف عن الحكم الشرعي في كل ما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة.
الثاني: أن العقل حاكم، فيكون مصدراً مستقلاً في طول الكتاب والسنة، ويمكن للفقيه الاعتماد عليه في حكم كل موضوع لم يرد في الكتاب والسنة بيان لحكمه.
الثالث: حصر وظيفة العقل في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الخاصة التي هي الكتاب والسنة.
ويعتمد أصحاب القول الأول في دعواهم بفسح المجال لتدخل العقل في التشريع على عدم بيان الشريعة لأحكام جميع الموضوعات.
ولا ريب في بطلان هذا القول، لدلالة جملة من الآيات على حصر حق التشريع في الله سبحانه وتعالى، وأنه يحرم على الإنسان التدخل في ذلك، قال تعالى:- (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، ومن المعلوم انحصار ذلك في خصوص الكتاب والسنة.
وقوله تعالى:- (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، مضافاً إلى النصوص التي يستفاد منها أن الإنسان غير مكلف بالتشريع لعدم قدرته على معرفة ما يرضي الله سبحانه وما يسخطه لعدم إحاطته بالملاكات الواقعية التي يقوم عليها التشريع وتبتني عليها الاحكام الإلهية، مثل ما جاء عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: ليس لله على خلقه أن يعرفوا، وللخلق على الله أن يعرفهم، ولله على الخلق إذا عرفوا أن يقبلوا. مضافاً للقاعدة المعروفة أن لله تعالى في كل واقعة حكماً.