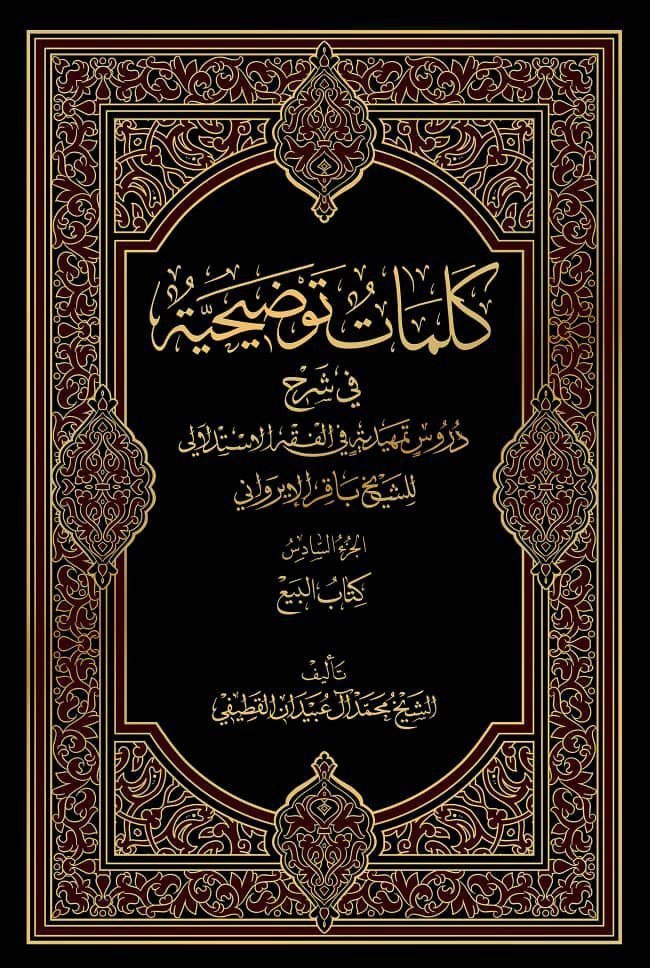التقليد في العقائد
المعروف بين أعلامنا البناء على مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية المعروفة بفروع الدين، فيمكن للمكلف أن يقلد في أحكام الصلاة والصوم والخمس والحج والجهاد، وغير ذلك.
وقد وقع الكلام في مشروعية ذلك في العقائد، وأنه هل يجوز التقليد فيها مطلقاً كما في المسائل الفرعية، أم يقرر عدم الجواز فيها مطلقاً من دون فرق بين مسألة ومسألة أخرى، وعليه يلزم أن يكون المكلف مجتهداً في ما يعتقد، فيستند إلى دليل في إثبات وجود الصانع أو نبوة النبي الأكرم محمد(ص)، أو إمامة الإمام، أو المعاد، وكذا في ثبوت البداء، وثبوت الرجعة، ووجود الجنة والنار، والصراط، والميزان، وهكذا. بحيث أنه لو سأل عن شيء مما ذكر فإنه يذكر دليله الذي استند إليه وأوصله إلى تلك المعرفة. أم يحكم بالتفصيل بين القولين السابقين، فلا يلتـزم بالجواز مطلقاً، ولا بالمنع كذلك، وإنما يبنى على جواز التقليد في بعض المسائل العقدية، وعدم جوازه في مسائل عقدية أخرى.
ثم إنه لو بني على عدم مشروعية التقليد في العقائد، يأتي سؤال مهم، وحاصله: هل أن المكلفين مجتهدون في المسائل العقائدية، أم أنهم مقلدون فيها؟ فالمستضعف، وحديث العهد بالبلوغ، هل هما مؤمنان بعقائدهما وأصول دينهما عن دليل واجتهاد، وأنهما قد ألتزما بذلك بعدما قاما بإعمال النظر والاستدلال، فآمنا بهذه المسائل، أم أنهما مقلدان في العقيدة، والشريعة، بمعنى أنهما قد نشأ في محيط يؤمن بهذه الأمور، فأصبحا مؤمنين بها، متأثرين بالأجواء المحيطة بهما وحولهما.
مفاهيم مرتبطة بالبحث:
يحتاج الحديث حول هذا الموضوع إلى الإحاطة ببعض المفردات المستعملة في كلمات الأعلام يلزم الإحاطة بمضامينها ومعانيها، نشير إلى بعض منها:
التقليد:
إن أول ما يلزم تحديد المقصود منه، هو بيان معنى مفهوم التقليد المذكور، سواء قيل بمشروعية التقليد في العقائد، أم قيل بعدم مشروعيته، أم حكم بالتفصيل. وقد ذكر في المقام احتمالات:
الأول: أن يكون المقصود منه هو المعنى المصطلح، والمذكور في كلمات الفقهاء، وهو عبارة عن الأخذ بقول الغير من دون دليل حتى لو كان قوله لا يورث إلا الظن، بل حتى مع الظن بخلافه.
ويؤيد هذا الاحتمال المقابلة بين التقليد في الأحكام والتقليد في العقيدة، ما يعني أنهما من سنخية واحدة ولا فرق بينهما فيها، وأنه يجوز التقليد في الأحكام، ولا يجوز التقليد في الاعتقادات.
وقد أجيب عنه، بأنه يعتبر في الاعتقاد أخذ قيد عقد القلب، وهذا لا يجتمع مع الشك فضلاً عن الظن، فإن أدنى مراتب الاعتقاد هو الظن، ولا يعقل التقليد بهذا المعنى في المسائل العقائدية، كيما يقع الكلام في جوازه ومشروعيته من عدمه.
والحاصل، إن المعنى المذكور للتقليد أجنبي تماماً عن مورد البحث، لأخذ قيد في حقيقة الاعتقاد، لا يتضمنه التعريف المذكور.
الثاني: أن يكون المقصود منه هو العمل بالظن، كما نقل ذلك عن الشيخ البهائي(ره)، من أن النـزاع في جواز التقليد وعدمه، يرجع إلى النـزاع في كفاية الظن وعدمه، وتوضيح ذلك أن يقال:
إن هاهنا مسألتين:
الأولى: جواز التقليد في أصول الدين.
الثانية: كفاية الظن في المسائل العقدية، وعدم لزوم تحصيل المعرفة والعلم والجزم. وكأن الشيخ البهائي(ره) يرجع المسألة الأولى للمسألة الثانية، فيجعل مسألة جواز التقليد في أصول الدين من صغريات كفاية الظن في المسألة العقدية، فمن قال بكفاية ذلك، بنى على مشروعية التقليد في أصول الدين، ومن لم يلتـزم بكفاية الظن في المسائل العقدية، قال بعدم مشروعيته فيها.
وأجيب عنه، بمنع رجوع المسألة الأولى للمسألة الثانية، بل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، وهذا يعني أنه حتى لو بني على كفاية الظن في المسألة العقدية، لن يلتـزم بمشروعية التقليد في أصول الدين.
الثالث: المعنى العرفي للتقليد، وهو بمعنى المتابعة والاقتداء بالغير لا لدليل، بل لمجرد أن الغير فعل ذلك أو قاله.
وهذا المعنى هو الذي ورد ذمه في القرآن الكريم، فتضمنت العديد من الآيات النهي عن متابعة الآباء والأمهات، قال تعالى:- (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون). وقال عز من قائل:- (قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)، وقال سبحانه:- (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا). وغيرها من الآيات الناهية عن متابعة الغير والذامة للتقليد والمتابعة من دون اطلاع وفحص.
وهذا المعنى للتقليد، قام الدليل على مشروعيته في الأحكام، ولم يقم دليل على مشروعيته في العقائد، بل الدليل قائم على منع مشروعيته، فإن المستفاد من الآيات كما سمعت هو المنع منه.
الرابع: أن يراد من التقليد في المسألة محل البحث، هو ما يحصل به العلم من دون استدلال، فيكفي مطلق الاعتقاد الجزمي، حتى لو كان حاصلاً من تقليد الآباء والأمهات. ولا يعتبر في الأصول العقائدية أن تكون حاصلة من خلال الاستدلال البرهاني.
والمعروف أن العلماء لا يعتبرون في العقائد أكثر من حصول الاعتقاد الجزمي، من دون ملاحظة منهم لمنشأ هذا الاعتقاد وكيفية تحققه وحصوله، بحيث يرتب عليه الأثر حتى لو كان حاصلاً من غير الاستدلال البرهاني.
وقد بنى بعض الأساتذة(وفقه الله) على أن هذا المحتمل هو المعنى المقصود في كلمات الأعلام عند الحديث حول مسألة التقليد في المسألة العقدية[1].
ولا يخفى أنه لا فرق بين المعنى الأول والمعنى الرابع، خصوصاً مع البناء على عدم ثبوت حقيقة شرعية للتقليد، وأن المقصود منه هو معناه العرفي، والمتابعة المأخوذة عند العرف، لا تخرج عن كونها الأخذ بقول الغير، والعمل على طبق قوله، ومتابعته. وهذا يتفق أيضاً مع المعنى الثالث، بل إن المعنى الثاني والذي حكي تقريبه عن الشيخ البهائي(ره)، لا يخرج عن ذلك.
وبالجملة، إن المقصود من التقليد بحسب الظاهر في كلمات الأعلام في المسألة العقدية، هو عين ما يذكرونه من التقليد في الأحكام الفرعية. نعم أخذ قيد في المسألة العقدية، لا يعني إرادة معنى آخر، وإنما يفيد أنه لن يجري عندها، والبناء على جريانه، يشير إلى عدم اعتبار ذلك القيد عند من قال بجريانه.
وبالجملة، ليس المقصود من التقليد في المقام شيئاً آخر غير التقليد المذكور في كلمات الأعلام في مسألة التقليد في الفروع.
وأما البناء على منعه في العقائد، وقبول جريانه في الأحكام مع أنهما من واد واحد، فذلك يعود للدليل، إذ أن عمدة ما يستند إليه في مشروعية التقليد هو السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل للعالم، وهي غير مردوع عنها في الأحكام، إلا أن الآيات الذامة لتبعية الآباء والأمهات، بناء على اختصاصها بالعقائد، أو بأصول الدين، تصلح أن تكون رادعة عن السيرة المذكورة.
هذا ويظهر من بعض الأساتذة(دام ظله) اختيار معنى آخر في حقيقة التقليد في المسألة العقدية، يختلف عنه في المسألة الفرعية الفقهية، وكلامه لا يخلو عن تشويش، فقد ذكر في البداية أن للتقليد في العقائد مراتب ثلاث، وهي:
1-التقليد في الفتوى.
2-التقليد في الدليل.
3-التقليد في الفتوى والدليل معاً.
أما التقليد في الفتوى، فهو الحد الأقصى من التقليد، وهو مشابه في الشكل للتقليد في الشريعة، نظراً لوجود فرق بين درجة الاطمئنان المفروض تحققها في تقليد الفتوى العقائدية، وأن المقلد من جملة حقوقه المعرفية تجاه مقلده طلب الايضاحات الممكنة للخلفيات العلمية للفتوى بخلاف ما عليه الحال فيا لتقليد في الفتوى الفقهية.
وأما التقليد في الدليل، فيراد به الحد الأدنى من التقليد، وفيه يكون المقلد عارفاً بالخلفية العلمية للمسألة العقائدية على نحو من التفصيل، بحيث يكون واقفاً على الدليل بالمقدار الذي يرفع عنه حرج السؤال.
وأما التقليد في الفتوى والدليل معاً، فيراد به الجمع بين المرتبتين السابقتين، وهي المرتبة التي ينبغي أن يكون عليها حال جميع المكلفين غير المجتهدين، فلا يتصور في حق المكلفين الاكتفاء في التقليد في الفتوى، إلا في المسائل التي صح فيها التقليد نظراً لوجود مسائل لا يجوز التقليد فيها أبداً، بل يجب فيها الاجتهاد أو فهم الدليل المعتبر[2].
ولم يتضح لي وجه اختلاف التقليد في الفتوى العقدية عنه فيا لفتوى الفرعية الفقهية، ومجرد ملاحظة عنصر الاطمئنان الموجب لتحقق عقد القلب، مانع من حصول التبعية للغير، بل سوف يكون مستنداً لما تولد عنده من اطمئنان، وهذا يمنع أن يكون هناك تقليد في الحقيقة.
على أنه لو رفعنا اليد عن ذلك، فإنه لم يتضح لي معنى وجيه للتقليد في الفتوى والدليل معاً، فضلاً عن التقليد في الدليل، لأنه لو كان المقصود منه التقليد في مقدماته، فإنه لا يعد تقليداً في الأمر العقدي، ولو كان تقليداً في نتيجته، لم يكن تقليداً في الدليل كما لا يخفى.
وللعلم فإن الأستاذ(وفقه الله) لا يختلف والأعلام في عدم مشروعية التقليد في أصول الدين، وإن وقع الخلاف في عددها، وأنه إنما يلتـزم بجريان التقليد في غيرها، كما نص على ذلك صريحاً، قال(حفظه الله): إن العناوين الثلاثة المتمثلة بالتوحيد والنبوة والمعاد لا يجوز التقليد فيها، سواء كان المكلف قادراً على الاجتهاد، أو غير قادر[3].
مع أن تجويزه التقليد في المسائل العقدية الأخرى، شرطه بحال عدم تمكن المكلف من التقليد في الدليل كي ما يسوغ له التقليد في الفتوى، وإلا فلا[4].
الاجتهاد:
الظاهر أنه لا يختلف المقصود من الاجتهاد في المقام عن الاجتهاد المذكور في البحث الفقهي، فكما أن المقصود به هناك النظر والاستدلال لإقامة الحجة والبرهان، من خلال ملاحظة الموارد التي يتوصل منها لمعرفة الأمر، كذلك في المقام، نعم يختلف الاجتهاد في المقام من فرد لآخر، فليس المطلوب من عالم الدين، عين ما يطلب من المزارع، والإنسان البسيط، وهكذا.
ومنه يتضح أن التعبير الوارد في كلمات بعض الأعلام، من أنه ليس المقصود من الاجتهاد في المقام الاجتهاد الاصطلاحي وهو قسيم الاحتياط والتقليد، قد لوحظ فيه ما ذكرناه من تفاوت حالة الأفراد، وإلا فالمحصلة في الاثنين هي الاستناد إلى حجة شرعية ودليل وبرهان على ما يعتقد.
الإيمان، التدين، عقد القلب:
ترد هذه المفاهيم كثيراً في البحث حول مسألة الاعتقاد، وما يعتقد، وقد يتصور للوهلة الأولى وجود المغايرة بين المفاهيم الثلاثة، وأن كل واحد منها يشير لمعنى يختلف عما يشير له المعنى الآخر، فالإيمان يشير إلى معنى يختلف عن التدين، وهو يختلف أيضاً عن عقد القلب. وهذا ما ألتـزمه غير واحد من الباحثين، والأعلام.
إلا أن الصحيح وحدة المفاهيم المذكورة، وأنها جميعها تشير إلى حقيقة واحدة، وإن أختلف التعبير عنها، فالإيمان والتدين، وعقد القلب كلها تعني الاعتقاد وتشير إلى ذلك.
المعرفة:
والمراد منها في البين العلم واليقين، فإذا قيل: يجب تحصيل المعرفة في أصول الدين، كان المقصود من ذلك أنه يجب حصول اليقين والعلم بها.
التصديق:
وقد وقع الخلاف في هذه المفردة أيضاً، فقيل بأنها تختلف عن الاعتقاد، وأن كل واحد منهما يشير لمعنى يختلف عن الآخر. وقيل بأنهما يشيران إلى معنى واحد، وأنهما متحدان، وهذا هو الأقرب.
التقليد في العقائد:
ونقصد بذلك الأعم من أصول الدين ومن المسائل الاعتقادية الأخرى، وقد وقع الخلاف في تحديد عدد أصول الدين، ولسنا بصدد الحديث عن ذلك، نعم المعروف أنها خمسة، وقد ذكرت أقوال أخر.
وعلى أي حال، فقد وقع الخلاف في مشروعية التقليد في أصول الدين، على أقوال ثلاثة:
الأول: البناء على عدم مشروعية التقليد فيها، ولزوم النظر والاجتهاد فيها. قال العلامة الحلي(ره): أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى، صفاته الثبوتية والسلبية، وما يصح عليه، وما يمتنع عنه والنبوة والامامة والمعاد بالدليل، لا بالتقليد[5].
الثاني: الالتزام بمشروعية التقليد في أصول الدين، كمشروعيته في فروع الدين من دون فرق بينهما. ولم ينسب القول به لأحد من الأعلام، مع أنه مذكور في كلماتهم عند استعراضهم الأقوال في المسألة.
الثالث: التفصيل، فيلتـزم بجوازه ومشروعيته في موارد دون أخرى، فيبنى على جواز التقليد فيها إذا كان الاجتهاد سوف يوجب الوقوع في الضلالة، ويحكم بعدم مشروعية ذلك ما لم يكن الاجتهاد مستلزماً لذلك. وقد أختار هذا القول السيد الحكيم(ره) في مستمسكه، واستند في ذلك إلى النصوص الناهية عن الخوض في مسائل القضاء والقدر ونحوها.
والإنصاف، أن عدّ التفصيل قولاً ثالثاً قسيماً للقولين السابقين خلاف الدقة، إذ أنه بمثابة الحكم الثانوي لأي من القولين، وبالتالي لا يعدّ مستقلاً عن أيهما، فتأمل.
وكيف ما كان، فقد ذكرت أدلة عقلية وأدلة سمعية على وجوب المعرفة، ومع أن ذلك يطلب من البحوث التخصصية في علم الكلام، إلا أنه لا مانع من الإشارة إلى ذلك بنحو موجز ومختصر لبعضها:
منها: وجوب شكر المنعم:
فإن الإنسان لم يكن ثم كان، ولم تكن له النعم والكمالات التي وجدت عنده من العلم والقدرة، وجميع ذلك من الغير وليس منه، وهي نعم، فتكشف عن وجود منعم قد أنعم بها عليها، ولا ريب في إدراك العقل لحسن شكر المنعم، وأن عدم شكره موجب للذم والمؤاخذة، ومن الواضح أن شكر المنعم فرع معرفته، فلابد من معرفته ليتم شكره، فيثبت أن المعرفة واجبة، لأنها طريق الوصول إلى شكر المنعم.
ومنها: وجوب دفع الضرر المحتمل:
لأنه مع ترك المعرفة والنظر يحتمل الوقوع في الضرر الأخروي، ولا ريب في أن دفع ذلك واجب، ولا يتحقق دفعه إلا من خلال تحصيل المعرفة، فتكون واجبة بحكم العقل.
ولا يخفى مدى الفرق بين الدليلين، فإن الثاني منهما أوسع من حيث الدلالة على لزوم المعرفة، فإن دفع الضرر المحتمل يستوجب معرفة كل ما يكون سبباً لرفع ذلك، فيلزم معرفة الصانع سبحانه، ومعرفة أنبيائه ورسله، والأوصياء(ع)، ومعرفة المعاد.
وهذا بخلافه على الدليل الأول، إذ مقتضاه حصر وجوب المعرفة في شكر المنعم الحقيقي، وهو الصانع سبحانه وتعالى، فلا يلزم معرفة شيء آخر، فلا يجب معرفة النبي(ص)، ولا معرفة الإمام(ع)، ولا المعاد.
وبعبارة دقيقة، ليس للدليل المذكور إطلاق ليكون شاملاً معرفة شيء آخر غير الباري سبحانه وتعالى.
نعم قد يوجه وجوب معرفتهم من خلال هذا الدليل بأحد بيانين:
الأول: ما ذكره المحقق الخراساني(ره) في الكفاية، وحاصله: أن طريق شكره سبحانه وتعالى لا يكون إلا من خلال الأنبياء والمرسلين والأوصياء(ع)، لأنهم وسائط نعمه على الناس، فيجب شكرهم المتوقف على معرفتهم[6].
الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني(ره)، وحاصله: إن الطريق لشكر المنعم الحقيقي لا يكون إلا من خلالهم، لأنهم وسائط التشريع بعد قصور النفوس البشرية عن تلقي الوحي الإلهي، وهذا يعني أن شكر المنعم لا يعرفه كل أحد من الناس إلا من طريقهم(ع)، فيلزم معرفتهم ليمكن شكر المنعم على الوجه المطلوب[7].
ومنها: قوله تعالى:- (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)[8]، فقد فسرت العبادة في الآية بالمعرفة، فيكون الهدف من خلقهم المعرفة، ويكون المعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون.
وقد أشكل على الاستدلال بها، أنه لم يرد في شيء من النصوص الواردة عن طريق المعصومين(ع) تفسير العبادة في الآية الشريفة بالمعرفة، نعم ذكر المحقق الأصفهاني(ره) أن التفسير المذكور مأخوذ من مصادر الجمهور.
على أنه لو سلم دلالتها فإنها لا تخرج عن الدلالة على لزوم معرفة الصانع سبحانه وتعالى، ولا دلالة لها على لزوم معرفة غيره، والاعتقاد بشيء آخر من العقائد.
هذا كله بعد التسليم بإمكانية الاستناد إلى الأدلة السمعية في الأمور العقدية، وأنه لا يلزم الدور، وأن الصحيح ما قرر في محله من التفصيل بالالتزام بإمكانية الاستناد إليها في بعض المسائل العقدية، كالإمامة مثلاً والمعاد، وعدم صحة الاستناد إليها في أمور أخرى كإثبات الصانع مثلاً.
تحديد المعرفة الواجبة:
والذي يهم الحديث عنه هو تحديد المعرفة الواجبة، والتي لا يجوز التقليد فيها، وقام الدليل والبرهان عليه، وأن ذلك يشمل جميع المسائل الأصولية العقدية، فلا يصح التقليد في شيء منها، أو أنه يلتـزم بالتفصيل في المسائل العقدية الأصلية، فيحكم بمشروعية التقليد في بعضها، وعدم مشروعيته في البقية؟ ولو بني على الثاني، فلابد من تحديد المناط في ذلك.
إن الإجابة عن ذلك تتضح من خلال ما تضمنه كلام الشيخ الأعظم الأنصاري(ره)، فقد قسم المسائل العقدية إلى قسمين:
الأول: ما يجب على المكلف الاعتقاد به مطلقاً من دون تعليق على حصول العلم، فيكون ملزماً بذلك، وإن لم يحصل له العلم به.
الثاني: ما يجب التدين به معلقاً على ما إذا حصل العلم به، فما لم يحصل لم يلزم ذلك، ولذا يعدّ العلم به من مقدمات الواجب المشروط.
وقد ذكر الشيخ الأعظم(ره) أن التميـيز بين الأمرين من المشكلات، ومن الأمور الصعبة جداً.
وقد فسر ما جاء في كلامه(ره) بأن المقصود من عدم وجوب الاعتقاد والتدين في القسم الثاني، هو عدم وجوب الاعتقاد التفصيلي الذي يكون عن علم عادة، دن الاعتقاد الإجمالي، فإنه يمكن الالتـزام بوجوبه، فيقال: يجب على المكلف أن يعتقد بمسائل القضاء والقدر وهكذا بقية المسائل العقدية.
ووفقاً لما ذكره(ره) سوف يكون وجوب تحصيل المعرفة مختصاً بالقسم الأول دون الثاني، فلا يلزم فيه ذلك. نعم يجب الاعتقاد التفصيلي حال حصول العلم به.
ومن العقائد التي تدخل تحت القسم الأول:
1-الاعتقاد بوجود الصانع سبحانه وتعالى.
2-الاعتقاد بنبوة النبي الأكرم محمد(ص).
3-الاعتقاد بإمامة الأئمة الأطهار(ع)، والبراءة من أعدائهم.
4-الاعتقاد بالمعاد الجسماني يوم القيامة.
وأما ما عداها من التفاصيل والجزئيات فلا يجب فيها ذلك، بل قد لا يجب حتى الاعتقاد ما لم يحصل العلم. نعم لا يجوز الانكار مع فرض حصول العلم بها. وهذا ما صرح به صاحب الكفاية(ره).
وما يجب معرفته في الأمور التي يلزم المعرفة فيها يختص بما يكون راجعاً لوجوب شكر المنعم لو كان دليل وجوب المعرفة هو، فلا تجب المعرفة بدقائق الأمور وتفاصيلها كما لا يخفى.
ومثل ذلك لو كان الدليل هو دفع الضرر فإنه ينحصر الوجوب في ما يكون محققاً لدفع الضرر، أما أكثر من ذلك فلا تجب معرفته.
والظاهر أن منشأ ما جاء في كلمات الأعلام(رض) من وجوب المعرفة في أصول الدين الخمسة، يعود لاستنادهم إلى جملة من النصوص، يمكن الوقوف عليها في مظانها، إلا أن ما نود التأكيد عليه أن دلالة الأدلة السمعية على وجوب المعرفة في الأصول الخمسة، لا تعني لزومها في التفصيلات والجزئيات، بل ينحصر الوجوب في جوانب محددة:
فيستفاد منها بالنسبة للأصل الأول وهو التوحيد، أنه يجب التصديق بوجوده سبحانه، وأنه واجب الوجود، والتصديق بصفاته الثبوتية التي تعود إلى صفتي العلم والقدرة، ونفي الصفات السلبية عنه الراجعة إلى الحدوث والحاجة، وأنه سبحانه لا يصدر منه القبيح.
وبالنسبة لأصل النبوة، يلزم معرفة شخص النبي، بالنسب، والتصديق بنبوته، وأنه صادق معصوم من الخطأ والاشتباه.
وفي الإمامة لابد من معرفة الأئمة(ع) بنسبهم، والتصديق بكونهم خلفاء الله سبحانه بعد نبيه في الأرض، وأنه تعالى قد فرض طاعتهم.
والتصديق بالمعاد الجسماني يوم القيامة، وأن الله تعالى يبعث من في القبور.
ووفقاً لما تقدم، ينحصر وجوب المعرفة التي لا يجوز التقليد فيها في المسائل الاعتقادية في خصوص ما ذكر، أما غير ذلك من الأمور، فلا يلزم فيها أن يكون المكلف مجتهداً ولا معتقداً فيها استناداً إلى الدليل، بل يمكن أن يكون فيها متبعاً للغير، مع أنه يمكن البناء على أن تبعية الغير في المسألة العقدية في الحقيقة تعود إلى استناد التابع إلى دليل المتبع، فهو يطمأن إلى وجود دليل عنده، وثقة منه بصحة دليله الذي استند إليه قد اتبعه، فتأمل.
بقية المسائل العقدية:
ومع أن مقتضى ما تقدم ذكره من حصر وجوب المعرفة في خصوص ما سبق وذكرناه، وبالتالي يتضح أنه لا تجب المعرفة في البقية من المسائل العقدية، كتفاصيل البرزخ، والمعاد، والقضاء والقدر، وكيفية الحشر، وإمكان رؤية الله تعالى، والتجسيم، ورؤية الإمام المهدي(عج)، والهجوم على بيت السيدة الزهراء(ع)، وأفضلية الأئمة الأطهار(ع) على الأنبياء(ع)، وأمثال ذلك، إلا أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين:
الأول: ما يدخل في ضروريات الدين:
لكونه قد ثبت أنه من الدين بالضرورة، وذلك مثل: السؤال في القبر، والحساب، والصراط، والجنة والنار، وأحوال المبدأ والمعاد، وما شابه ذلك، وفي هذا القسم من حيث وجوب الإيمان والتدين والاعتقاد احتمالات ثلاثة:
أحدها: اشتراط الاعتقاد بها، فلا يكون الإنسان مؤمناً إلا إذا اعتقد وألتـزم بها.
ثانيها: وهو المشهور، عدم اعتبار الاعتقاد بها، نعم يشترط عدم انكارها، والمنكر لها يخرج عن الإيمان، سواء علم بها أم لم يعلم.
ثالثها: وهو مختار كثير من الأعلام، عدم اعتبار الاعتقاد بها، كما لا يشترط عدم انكارها، نعم إذا علم أنها من الدين لزمه الاعتقاد بها، ولم يجز له إنكارها.
ومقتضى القول الثالث الذي أختاره المقدس الأردبيلي، والشيخ الأنصاري(ره)، وغيرهما، أنه لا يجب الاعتقاد بهذه المسائل حتى بعد العلم بها.
وقد عرفت عند تحديد المعرفة الواجبة بطلان الاحتمال الأول، لأن مقتضاه سعة ما تجب معرفته، وقد عرفت في ما تقدم ضيق ما تجب معرفته.
الثاني: ما ليس من ضروريات الدين:
فلم يثبت أنه من الدين بالضرورة، وذلك مثل: رؤية الله سبحانه، والتفويض، والهجوم على بيت السيدة الزهراء(ع)، ورؤية الإمام الحجة المنتظر(روحي لتراب حافر جواده الفداء)، وأمثال ذلك.
والظاهر أنه لا يوجد إشكال في عدم وجوب الاعتقاد بهذه الأمور والتدين بها، فلا يضر عدمها في وجود صفة الإيمان، ولا في تحقق الإسلام، كما أنه قد عرفت عدم وجوب تحصيل المعرفة فيها. نعم من حصل له علم بها، لم يجز له إنكارها[9].
خاتمة:
بقي أن يشار في نهاية المطاف إلى حكم الجاهل القاصر من حيث وجوب المعرفة ولزوم تحصيل الدليل عليها، ككثير من النساء، بل وكثير من الرجال، والبالغين حديثاً، ومن دخل في الإسلام جديداً، وكذا المستضعف، بعد البناء على وجود الجاهل القاصر في شأن ذلك، لأن هناك من أنكر وجوده، واستند في ذلك إلى أمور:
أحدها: الإجماع على عدم معذورية المخطئ في العقائد، وهذا يستوجب عدم وجود جاهل قاصر.
وهو ممنوع، لأن الإجماع منعقد على الجاهل المقصر، وليس القاصر، على أنه دليل لبيي لا لسان له، ولم يحرز أن معقده مطلق الجاهل، فتأمل.
ثانيها: التمسك بقوله تعالى:- (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)[10]، لأن المقصود من العبادة هي المعرفة.
وقد عرفت الجواب عنها عند استعراض بعض الأدلة المستند إليها في وجوب المعرفة، ولزوم تحصيل الدليل عليها.
مع أنه قد ينقض على الاستدلال بها لو رفعت اليد عما قدم، بموت الأطفال والمجانين، فإنهم لم يعرفوا، فهل يعقل أن يكون مصيرهم إلى النار، مع أنهم غير مكلفين.
وإن قيل: إنهم معذورون لرفع القلم عنه، كان ذلك موجباً لاستثناء القاصر أيضاً، لنفس الملاك، فتأمل.
وللشيخ الأعظم الأنصاري(ره) كلام ذكره في الفرائد لإثبات عدم وجود الجاهل القاصر، يمكن لذوي الاختصاص والباحثين الرجوع إليه، لأن ذكره يخرج عن موضوع هذا المختصر.
ثم إنه بعد الفراغ عن وجود الجاهل القاصر خارجاً لمناقشة أدلة المانعين من وجوده، يلزم تحديد حكمه، وأنه كافر أو لا؟
إن مقتضى ما ذكره المتكلمون من انتفاء الواسطة بين الإيمان والكفر، تستوجب أن يكون كافراً، لأنه لا ريب في عدم كونه مؤمناً، فيثبت الآخر. وهو صحيح إلا أنه هل يطلق عليه في المصطلح الشرعي ذلك المستفاد من القرآن الكريم والسنة المباركة ذلك أم لا؟
الصحيح أن المستفاد من النصوص، أن هناك حالة وسطية بين الإيمان والكفر، يكون فيها الجاهل القاصر، فهو ليس مؤمناً وليس كافراً. فعن حمران، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن المستضعفين، قال: إنهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافرين، وهو المرجون لأمر الله[11].
ولما لم يكن مؤمناً ولا كافراً، فإن الأحكام الفقهية الوضعية الثابتة في حق الكافر من النجاسة وحرمة الذبيحة، وحرمة التزويج، لن تكون منطبقة عليه، لأنه لابد من أن يرجع إلى انكار الرسالة وتكذيبها، وليس هو كذلك.
وبناء عليه، لن يكون مستحقاً للعقوبة حينئذٍ، لأن العقوبة موضوعها الجاهل المقصر دون الجاهل القاصر.
[1] مجلة المنهاج العدد 50 ص 28-29.
[2] فقه العقيدة ص 127-130.
[3] المصدر السابق ص 133.
[4] المصدر السابق ص 133-134.
[5] الباب الحادي عشر
[6] كفاية الأصول ص 329-330.
[7] نهاية الدراية ج 2 ص 379-380.
[8] سورة الذاريات الآية رقم 56.
[9] مجلة المنهاج العدد 51 ص 35-37.
[10] سورة الذاريات
[11] بحار الأنوار ج 69 ح 29 ص 165.