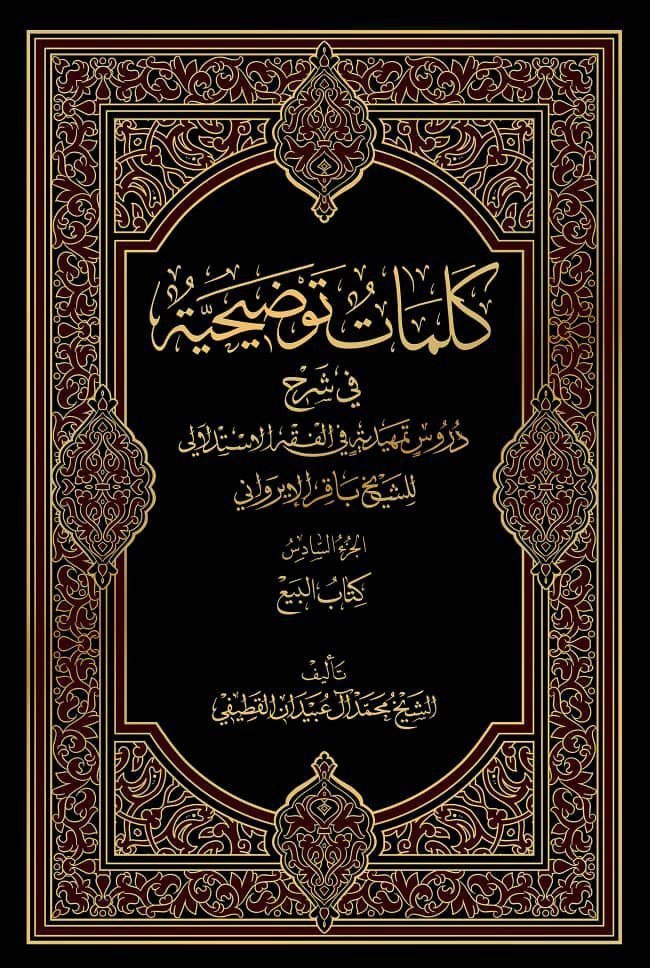قال تعالى:- (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين)[1].
مدخل:
لا ريب في أن كل مذهب سواء كان مذهباً مادياً أم كان مذهباً سماوياً، ينظر لبعض الأعمال نظرة إعجاب وتقدير بحسب ما ينطوي عليه ذلك المذهب من المفاهيم الفكرية والخُلقية وهكذا.
ويعبر عن هذه الأعمال، بالأعمال الصالحة، وهي من الأمور التي يندب إليها العقلاء، بل ورد حث الشرع الشريف على الإتيان بها.
ففي الإسلام على سبيل المثال، قد عدّ العمل الصالح بحسب ما يستفاد من القرآن الكريم، إحدى الوسائل التي يستفاد منها في عملية التكامل للنفس الإنسانية، وإحدى الطرق التي يسلك من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى، في سبيل تحصيل الدرجات العليا، قال سبحانه وتعالى:- (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً)[2]
المذهب الرأسمالي والماركسي:
وما ذكرناه من حث وإرشاد إلى إيجاد الأعمال الصالح في الواقع الخارجي، لا ينحصر في خصوص المفهوم الإسلامي، بل المذاهب الأخرى بما تملكه من طروحات، تدعو أيضاً إلى الأعمال المميزة والصالحة، وتندب المنـتمين إليها لإيجادها، نعم يخـتلفون عن الإسلام في تقيـيمهم للعمل الصالح.
فلو كان المذهب يحمل انطباعاً مادياً بحتاً كمذهب الرأسمالية، فإن أهمية العمل وكونه محط إعجاب وتقدير عندهم تظهر من خلال ما يمثله هذا العمل الصادر من العامل من مصلحة للمجتمع، ذلك لأن الرأسمالية مذهب يعنى بالمصالح الحياتية للمجتمع.
فالعمل الذي يشتمل على العناصر المقررة في هذا المذهب-الرأسمالي-والتي تعدّ بمثابة أسسه وقوانينه، من حيث كونه مشتملاً على منافع متبادلة للأفراد، ورافعاً لمستوى العلاقة بينهم، وعلى وفق مبدأ الحرية، فإنه يستحق أن يوصف حينئذٍ بكونه عملاً مميزاً، وأن له وجهة مقدرة. بل إن أسهم العمل من حيث التميز والمحبوبية ترتفع بمقدار ما يؤديه العمل في الوسط الاجتماعي من نتاج.
فما يصدر من الأغنياء تجاه الفقراء من تقديم مساعدات فصلية كالشتاء مثلاً، أم على نحو الآن والوقت، يعدُّ من أعظم الأعمال وأزكاها وإن لم تكن دوافع الغني خيرة، بل كانت دوافعه للإتيان بتلك الأعمال كسب الأصوات ونيل مدح الناس وإطرائهم، وتحصيل غاية يرجوها منهم.
وهذا المعنى في تحديد منشأ تميز العمل، وبروزه على أي عمل آخر، تتفق فيه الماركسية أيضاً مع الرأسمالية، نعم تخـتلف عنها في أن الماركسية لا تنظر للمجتمع بكافة طبقاته، وإنما تقيّم العمل من حيث ما يـبديه من نتاج للطبقة الجديدة دون الطبقة القديمة، فبمقدار ما يقدم لهذه الطبقة يقرر حسن العمل حينئذٍ وعدمه.
النظرة الإسلامية للعمل:
ولما كانت مفاهيم الإسلام وقيمه مخـتلفة تماماً عن هذين المذهبين في المفاهيم الأخلاقية والقيم والتعاليم والمقررات، كانت النظرة الإسلامية للعمل ومعيار تميزه ووصفه بكونه عملاً صالحاً مغايرة تماماً لهما.
فأول النقاط التي يلحظها الإسلام في إعطاء أي عمل من الأعمال قيمة ومقبولية من عدمها، هو ملاحظة الدافع الذي ينطلق العمل فيه لأداء ذلك العمل. وهذا يعني أن الإنسان يعتمد كثيراً على دوافع الأعمال لا منافعها، فلولا وجود النية الصالحة في هذا العمل لن يكون عملاً صالحاً وإن كثرت منافعه التي نشأت عنه.
بناء إنسان نظيف:
ومن الواضح أن هدف الإسلام في هذا المنحى المغاير للمذهبين المشار إليهما-الرأسمالي والماركسي-هو السعي إلى بناء شخصية متكاملة نظيفة في داخلها ومحتواها تـتوافق في قيمها وآدابها مع تعالميه ومفاهيمه وأطروحاته.
فليس المهم في التصور الإسلامي بناء العلاقات الاجتماعية وزيادة الروابط بين الأفراد، لأن هذا لا يمثل حقيقة يعتمد عليها في بناء المجتمع المتكامل، لأنه لا يمثل شيئاً في الحقيقة. بل يهدف الإسلام إلى بناء شخصية إسلامية، وبنائها روحياً وفكرياً وفق مفاهيمه وقيمه وطروحاته.
مقياس حسن العمل في الإسلام:
بناءاً على هذا يظهر أن مقياس العمل الصالح والمتميز عند الإسلام يبتني على الدوافع والمقدمات والأُطر الفكرية العامة التي تـتكون بذرة العمل ضمن نطاقها.
فهناك إذن إطار فكري عام يقرره الإسلام، وهناك دوافع أيضاً، أما الإطار الفكري فهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واليوم الآخر.
وأما الدوافع فهي تلك العواطف والميول الخيّرة التي تنسجم مع هذا الإطار العام.
ومتى تحقق اندراج هذين الأمرين واتحادهما روحاً، نتج عن ذلك الإنسان المؤمن، الذي ينبثق ويصدر منه العمل الصالح.
العمل الصالح:
وعلى هذا يمكن تعريف العمل الصالح وفقاً لما تقدم، بأنه: العمل المنبثق عن العواطف والميول الخيّرة المنسجمة مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر.
فليس ميزان العمل الصالح -وفقاً لهذا التعريف- في الإسلام، بمقدار ما يعود على المجتمع أو على أفراده من فائدة، تنجم عن ذلك العمل، بل الميزان هو توفر المقدمات المذكورة.
ولذا الشفقة من الإنسان على الأعمى، قد تكون من خيرة الأعمال وأحسنها في وجهة الإسلام، لما تمثله من دوافع إنسانية حية، ولأنها تشتمل على إيمان صادق بالله سبحانه وبوعده.
واقعية الإسلام دون غيره:
هذا ولكن ربما يعترض البعض، فيقول: إن المذاهب الأخرى أكثر واقعية من الإسلام في إبراز جنبة التقيـيم للعمل وإعطائه صفة التميز، إذ لا ريب في أن العقل والعقلاء يقدمون على العمل الذي يشتمل على مردود إيجابي لعدة أفراد، فما بالك لو كان العمل نافعاً لكافة أفراد المجتمع، فبناء مدرسة لأبناء المجتمع لا ريب في أفضليته وحسنه على مساعدة الأعمى ليعبر الطريق، ولا ريب في حسنه على دفع صدقة لفقير واحد، وعليه يكون التقدير والاحترام لمثل تلك الأعمال.
هذا وعندما نلحظ ما ذكر علينا الالتفات إلى أن الكلام المذكور يصح لو كانت الأبعاد المرجوة من العمل منحصرة في خصوص المردود على الأفراد والمجتمع في الخارج مع قطع النظر عن الفاعل الصادر منه الفعل، بمعنى أننا لا ننظر إلى هذا الفاعل وما ينبغي أن يكون عليه نتيجة فعله، بل ما يهمنا هو حصول المنفعة للأفراد والمجتمع، وبأي نحو كان ذلك، وبأي سبيل، ولا ربط لنا بما سوف يجنيه الفاعل من أثر أو فائدة.
أما لو كنا نلحظ الفرد الفاعل أيضاً، فلا ريب في أن الإسلام سوف يكون أكثر واقعية من غيره في هذه الناحية، ضرورة أن الإسلام يسعى إلى تربية نفس الشخص على الإتيان بالعمل.
ذلك لأن العمل الصالح من وجهة النظرة الإسلامية يترك أثراً في نفس الفاعل، ويكون إحدى الدوافع له نحو الرشد والتكامل، قال تعالى:- ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فألئك لهم الدرجات العلى)[3].
فالإسلام إذن ليس غايته من العمل الصالح مجرد تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، ولو من خلال أداء الحقوق والواجبات المطلوبة بينهم، بل يهدف الإسلام إلى أمرين أساسيـين:
الأول: صنع شخصية رسالية، إسلامية، يمنحها الحياة الخاصة، قال تعالى:- (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)[4].
الثاني: إن الرابط الروحي والفكري للإنسان عامل أساسي لاستمرار العمل، لأن الأعمال الأخرى التي تكون مجردة من الدوافع الروحية والإيمانية، وإن كانت حسنة في نفسها لكنها لما لم تكن منطلقة من أجواء خاصة، لا يضمن لها الاستمرارية والبقاء، بخلاف الأعمال الحسنة الصادرة من منابع وقيم إسلامية، فإن الدوافع الروحية والفكرية المحيطة بها تكون سبباً دائمياً لاستمراريتها وبقائها.
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام:
ومن خلال ما ذكرناه في بيان الميزان الإسلامي في وصف عمل من الأعمال بالتميز، وكونه عملاً صالحاً يتضح منشأ رفض القرن الكريم لجعل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عملاً يوجب التفضيل والتميز، ذلك لأن هذا العمل لم ينطبق عليه ميزان العمل الصالح المقرر في الإسلام، وليتضح المعنى أكثر نشير لما ورد في سبب نزول الآية الشريفة كما ذكر ذلك في غير واحد من كتب التفسير، فقد روي عن بريدة، أن شيـبة والعباس كان يفتخر كل منهما على صاحبه، وبينا هما يتفاخران إذ مرّ عليهما علي بن أبي طالب(ع)، فقال: فيما تتفاخران؟…
فقال العباس: حُبيت بما لم يحبَ به أحد، وهو سقاية الحاج.
فقال شيـبة: إني أعمر المسجد الحرام، وأنا سادن الكعبة.
فقال(ع): على أني مستحي منكما، فلي مع صغر سني ما ليس عندكما.
فقالا: وما ذاك؟!…
فقال: جاهدت بسيفي حتى آمنـتما بالله ورسوله(ص)، فخرج العباس مغضباً إلى النبي(ص) شاكياً علياً، فقال: ألا ترى ما يقول؟…
فقال النبي(ص): أدعو لي علياً، فلما جاءه علي، قال(ص): لِمَ كلمت عمك العباس بمثل هذا الكلام؟…
فقال(ع): إذا كنت أغضبته، فلما بينت الحق، فمن شاء فليرضَ بالقول الحق ومن شاء فليغضب.
فنـزل جبرئيل(ع) وقال: يا محمد، إن ربك يقرؤك السلام ويقول: أتل هذه الآيات:- (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله…).
حيث أن شيـبة والعباس افتخر كل منهما على صاحبه بما يقوم به من عمل، وجعل عمله أفضل الأعمال، لأنهما قاسا ذلك وفقاً لمردود الذي يعود على المجتمع وأفراده من خلال هذا العمل.
لكن القرآن الكريم يقدم النموذج الحق والصحيح في معيار المفاخرة والتفاضل في الأعمال، من خلال بيانه أن هذين العملين المذكوران لا ينهضان للتميـز على العمل الصادر من أمير المؤمنين(ع) متمثلاً في التوحيد والإيمان بالمعاد والجهاد في إعلاء كلمة الحق مع الدوافع الحسنة.
نموذج آخر:
ونفس هذا المضمون نجده في مورد آخر، عندما يتعرض القرآن الكريم لعمارة المسجد الحرام، فيشير إلى أن المشركين وإن صدر منهم ذلك، إلا أنه لن يكون عملاً صالحاً، قال تعالى:- (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون*إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)[5].
فالإعانات المالية الواصلة من المشركين لعمارة المسجد الحرام، لا قيمة لها أبداً ما داموا لا يملكون المعيار الحقيقي في العمل الصالح، لأن شهادتهم على أنفسهم بالكفر تمثل سبباً مانعاً من قبول أي شيء منهم.
نعم من هو جدير بالاحترام والتقدير للعمل الصادر منه هو من آمن بالله واليوم الآخر….الخ…
ويمكن أن يحمل المنع من عمارتهم بلحاظ عبادتهم، لأنها لن تكون إحياء لشعائر الله سبحانه، وليست إعمار لمحال ذكره، لأن عبادتهم لن تكون لله تعالى، إذ أنهم يقرون على أنفسهم أنهم غير موحدين له سبحانه، فما يصدر منهم لن يكون مورداً لعمارة بيت الله عز وجل.
الرياء مبطل للعمل:
ولعل عدم صلاحية المشركين لعمارة المسجد الحرام، توخى فيها الشارع المقدس جانباً آخر وهو الرياء، حيث أن هذا مدعاة للتفاخر بالعمل، وعدم كونه خالصاً لوجهه سبحانه وتعالى، وقد وردت النصوص الكثيرة المشيرة إلى رفض أي عبادة يشوبها الرياء، بل ورد أنه سبحانه وتعالى يترك كل عمل أشرك معه غيره فيه.
وقد عدّ الشارع المقدس العابد المرائي بعبادته مريضاً يحتاج إلى علاج ورعاية، واعتبر بقائه على حاله سبباً لانهيار المجتمع الإسلامي، لأنه يؤدي إلى تفشي هذا المرض في أوساطه.
صدقة السر:
وكتأكيد لأهمية الطهارة النفسية والنقاوة الإيمانية، حث الشارع على صدقة السر، ودعى إلى الإتيان ببعض ألوان البر في الخفاء، وذلك لما في ظهور هذه الأمور وشيوعها بين الناس من ميل للمدح والإطراء، فربما يشوب العمل حينها شائبة العجب والرياء، فحرصاً على خلوص النية وسلامة العمل، أهتم الشارع وأكد على كون ذلك في خصوص السر والخفاء، إلا في موارد أشير إليها في الكتب الفقهية[6].
——————————————————
[1] سورة التوبة الآية رقم 19.
[2] سورة الكهف الآية رقم 11.
[3] سورة طه الآية رقم 75.
[4] سورة الأنفال الآية رقم 24.
[5] سورة التوبة الآيتان رقم 17-18.
[6] مفاهيم إسلامية ص 185.